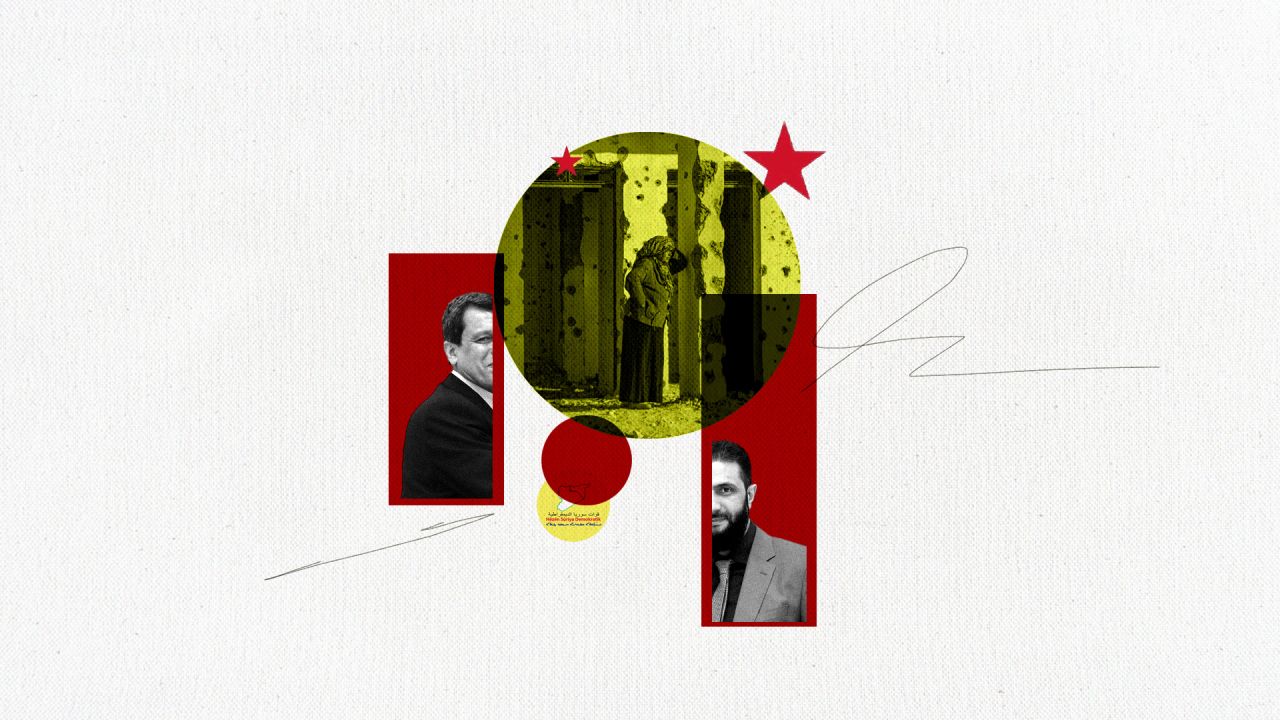على مدى سبعة أشهر منذ توقيع اتفاق 10 آذار/مارس بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بقي حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بمثابة "الدريئة السياسية" الوحيدة التي احتمى بها الطرفان من سهام المنتقدين والمشككين في جديتهما. ومع استنزاف تلك الدريئة سياسيًا، بدا أن الوقت قد حان للانقضاض عليها عسكريًا، فكانت أحداث السادس من تشرين الأول/أكتوبر، التي ستسجَّل في الذاكرة السورية كـ"غزوة الشيخ مقصود والأشرفية"، لتحلّ ربما محلّ حرب السادس من أكتوبر 1973 في الوجدان السوري المعاصر، ولكن بمعنى مغاير: معركة داخلية لا خارجية!
ويبدو السؤال الأهم الواجب الطرح اليوم: ما الأسباب الحقيقية وراء استعصاء تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس؟
أما الإجابة فلا تكمن في بند واحد أو عند طرف واحد، بل في شبكة مصالح متداخلة تتجاوز حدود سوريا.
أولًا: دمشق... خوف السلطة من تفوّق الداخل
تتعامل السلطة السورية الحالية مع "قسد" بوصفها الخطر الأكبر على نفوذها الداخلي خلال السنوات الانتقالية الخمس التي تخطط لها لتثبيت سلطتها. فالقوة العسكرية لـ"قسد" قد تتفوق ـــ من حيث التنظيم والانضباط والعتاد ـــ على الجيش السوري الجديد الذي أُعيد تشكيله بعد الحرب، فيما توسعت قاعدة الدعم الشعبي لـ"قسد" من مناطق سيطرتها في الشمال الشرقي لتحظى بامتدادات في السويداء والساحل وحماة وحمص وريفيهما، بل وربما حتى في بعض أوساط دمشق وحلب.
في حلب تحديدًا، كشفت اشتباكات الشيخ مقصود عن تململ صامت من سياسات السلطة، إذ لم تحظَ العمليات بتأييد شعبي، على خلاف ما حدث في مناطق أخرى. جزء من هذا الموقف نابع من رفض أهالي المدينة، خصوصًا من التيارات الصوفية والأشعرية، لمنطق السلاح، وجزء آخر هو تمرير غير مباشر لانتقادات أوسع تتعلق بالتهميش والضيق المعيشي وشعور بالترهيب السياسي.
ترى دمشق أن "قسد" تُماطل في تنفيذ الاتفاق، وتراهن على تغييرات إقليمية ودولية قد تمنحها ورقة قوة لاحقًا، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز قدراتها العسكرية استعدادًا لما يُوصف في الكواليس بـ"المعركة الكبرى". كما تتهم السلطة "قسد" بالتنسيق مع السويداء والساحل، واستقطاب مقاتلين من تلك المناطق وتدريبهم، بل وبتنسيقٍ غير مباشر مع إسرائيل، وهو اتهام متكرر في الخطاب الرسمي السوري كلما أرادت السلطة رفع سقف الضغط على خصومها.
ثانيًا: "قسد"... الثقة المفقودة والعقيدة المجهولة
في المقابل، تُحمّل "قسد" دمشق مسؤولية تعطيل الاتفاق، مستشهدة بصدور الإعلان الدستوري بعد أيام من توقيع اتفاق 10 آذار/مارس، بما يخالف بنوده الجوهرية. فبينما تكتفي دمشق بخطاب عام حول "ضمان حقوق جميع المكونات"، تطالب "قسد" بترجمة تلك الوعود في نص دستوري صريح، يقرّ باللامركزية ويكفل الإدارة الذاتية كصيغة شرعية لا مؤقتة.
الخلاف الأبرز يدور حول دمج "قسد" في الجيش السوري: دمشق تريدها أفرادًا متفرّقين، فيما تصرّ "قسد" على الاندماج ككتلة عسكرية واحدة، مشيرة إلى أن فصائل أخرى انضمت سابقًا بهذا الشكل مثل "العمشات" و"الحمزات" و"أحرار الشرقية" التي تحوّلت إلى فرق مرقّمة.
من وجهة نظر "قسد"، فإن الدمج الفردي يعني تفكيكًا كاملًا لبنيتها العسكرية وتسليم مقاتليها إلى مصير مجهول، خصوصًا إذا جرى فرزهم ضمن تشكيلات خاضعة لأوامر خارجية سبق أن أُرسلت للقتال في أذربيجان وليبيا.
عدم نجاح أنقرة في فرض استقرار داخل سوريا لا يعود إلى العوامل الميدانية فقط، بل إلى انقسام داخل السلطة التركية نفسها أيضًا
والأسئلة هنا كثيرة:
ما مصير مقاتلات وحدات حماية المرأة؟ كيف سيتعامل الجيش الجديد مع عقيدة مختلفة في المساواة والرمزية القتالية؟ ما هي عقيدة الجيش السوري الجديد أصلًا؟ وكيف يمكن لمقاتلٍ من قسد أن يجد موقعه في حال اندلاع اقتتال داخلي جديد في الساحل أو السويداء؟
أحداث الساحل والسويداء منحت سلاح ""قسد" رصيدًا إضافيًّا. فحتى بعض الخصوم السابقين باتوا يدعون للحفاظ على السلاح بوصفه ضمانة للبقاء، وهو ما جعل أيّ حديث عن تسليم السلاح أو الدمج الفردي أقرب إلى انتحار سياسي لـ"قسد" أمام جمهورها.
تضاف إلى ذلك المواقف الكردستانية الداعمة لـ"قسد". فقد صرّح نيجيرفان بارزاني عشية زيارته لأنقرة بأن "طلب دمشق من قسد الاندماج كأفراد خطأ استراتيجي"، مؤكدًا أن المركزية في الحكم السوري "أصبحت مستحيلة". كما سبقه مسعود بارزاني بتصريح تعهّد فيه بالتوجه شخصيًا إلى سوريا "لحماية المدنيين الكرد" إذا تعرّضوا لهجوم. هذه المواقف تُعيد للقضية السورية بعدًا كرديًا إقليميًا يتجاوز حدودها الإدارية.
ثالثًا: تركيا... وحدة منقسمة على نفسها
في مشهد لا يقل تعقيدًا، تتبدى تركيا كفاعل رئيسي ومتناقض في آن. فخلال لقاء جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان، هنّأ الأول الثاني على "الاستحواذ على سوريا"، في عبارة وُصفت بأنها ترجمة سياسية للوصاية التركية على الملف السوري. ومع ذلك، لم تنجح أنقرة في فرض استقرار داخل الأراضي السورية الواقعة تحت نفوذها، إذ تظل ساحات عديدة رهينة فوضى أمنية.
والسبب لا يقتصر على العوامل الميدانية، بل يمتد إلى انقسام داخل السلطة التركية نفسها. فـحزب "العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان، وحليفه حزب "الحركة القومية" بقيادة دولت بهتشلي، يختلفان في مقاربة الملف الكردي والسوري.
جناح هاكان فيدان (من أصول كردية سنية) يرى في أيّ تسوية بين دمشق و"قسد" خطرًا على تركيا، ويدفع نحو عمل عسكري جديد ضد "قسد"، معتبرًا أن إفشال الحوار بين الطرفين السوريين هو الطريق لضمان السيطرة الميدانية.
أما جناح إبراهيم كالن (من أصول كردية علوية) فيتبنّى رؤية معاكسة: إنّ التحالف التركي ـــ الكردي ـــ العربي هو صمام الأمان للمستقبل، وإن نجاح اتفاق 10 آذار/مارس جزء من خطة بعيدة المدى لضمان عدم تقسيم تركيا نفسها.
وراء هذه الخلافات يكمن ربما صراع خفي على خلافة أردوغان، يجعل كل جناح يسعى لإضعاف الآخر عبر ملفات إقليمية حساسة، منها الملف السوري.
رابعًا: واشنطن... الرعاية الغامضة
برغم أن واشنطن تُعد الراعي المعلن لكل من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، إلا أن كليهما يشتكي من ضبابية الموقف الأميركي. فليس هناك مشروع واضح المعالم، ولا التزام أميركي بجدول زمني أو إطار محدد لتطبيق اتفاق 10 آذار/مارس.
هل يُسقط اتفاقٌ جديد بين دمشق وأنقرة اتفاقَ 10 آذار/مارس بين دمشق و"قسد"، كما أسقطت اتفاقات الأمس أحلام الأمس؟
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تتعمد إبقاء الغموض لتوازن القوى بين الأطراف دون السماح لأيّ منها بالهيمنة المطلقة. إلا أن هذا الغموض نفسه يُنتج فراغًا سياسيًا تستغله قوى أخرى: تركيا في الشمال، وروسيا في الوسط، وإيران في الجنوب الشرقي.
خامسًا: بريطانيا تزيح فرنسا من "الساحة السورية"
منذ اتفاق سايكس ـــ بيكو، كانت سوريا ضمن الحصة الفرنسية، وظلّ الحضور الفرنسي قائمًا في بنية القرار السوري حتى عهد حافظ الأسد، الذي أوكل إلى جاك شيراك رعاية نجله بشار تمهيدًا لخلافته. لكن التطورات الأخيرة أظهرت بروز الدور البريطاني في الملف السوري على حساب باريس.
فقد أعلنت لندن أنها كانت أول الواصلين إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024، في خطوة بدت وكأنها انقلاب على الإرث الاستعماري القديم. ردّت باريس بمحاولة استضافة حوار بين السلطة السورية و"قسد"، لكنّ دمشق انسحبت فجأة من تلك المباحثات بحجة أن الحوار السوري يجب أن يكون على الأراضي السورية. النتيجة: خسرت فرنسا موقعها التقليدي في الملف السوري، وباتت لندن لاعبًا جديدًا في مرحلة ما قبل التسوية.
حصيلة سبعة أشهر: اتفاق معطّل وذاكرة مثقلة
عمليًا، لم يُنفّذ أيّ بند من اتفاق 10 آذار. الإنجاز الوحيد، اتفاق نيسان/أبريل حول إدارة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، سقط مع اشتباكات السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وبرغم التوتر، يسعى الطرفان إلى تحييد القادة عن تبادل الاتهامات: فدمشق تُبرّئ مظلوم عبدي وتتهم "جناحًا متشددًا داخل قسد"، فيما تتجنب "قسد" مهاجمة أحمد الشرع، وتُلقي باللوم على فصائل غير منضبطة أو تدخلات خارجية.
المفارقة أن العلاقة الشخصية بين الشرع وعبدي ـــ كما تسرّب من جلساتهما الخاصة ـــ تتجاوز البرود السياسي، إلى حدّ تبادل الحديث بالكردية، وكأن الكيمياء الشخصية بينهما تشكّل الجسر الوحيد المتبقي فوق هوّة الخلاف الأيديولوجي.
التاريخ يعيد نفسه في مرايا الشبه والمصادفة؟
يخبرنا التاريخ عن تحالف غريب جمع بين زعيم الحشاشين راشد الدين سنان وصلاح الدين الأيوبي: عدوّان تحوّل عداؤهما إلى شراكة ضد الصليبيين، حتى قيل إن راشد الدين سنان كلف نخبة من رجاله بحراسة صلاح الدين من محاولات الاغتيال. فهل يتكرر المشهد نفسه اليوم بشكل مختلف، بين عبدي والشرع، عدوي الأمس اللذين قد تفرض عليهما الضرورة تحالفًا غير معلن في وجه خصوم أكبر؟
كما يذكّرنا التاريخ الكردي الحديث بأن اتفاق 11 آذار/مارس 1970 بين الأكراد والحكومة العراقية سقط بعد خمس سنوات فقط بفعل اتفاق 6 آذار/مارس 1975 بين بغداد وطهران، بوساطة أميركية هي ذاتها التي رعت لاحقًا سقوط نظام بغداد وتأسيس إقليم كردستان.
من هنا يتردّد السؤال في الأوساط السورية اليوم:
هل يُسقط اتفاقٌ جديد بين دمشق وأنقرة اتفاقَ 10 آذار/مارس بين دمشق و"قسد"، كما أسقطت اتفاقات الأمس أحلام الأمس؟
التاريخ يقول إن هذا ممكن... وسوريا اليوم تبدو مهيأة لتكرار دروسها، حتى وإن غيّرت أسماء اللاعبين.